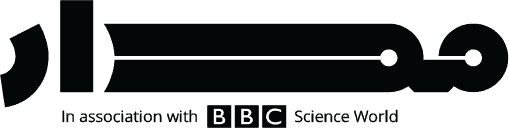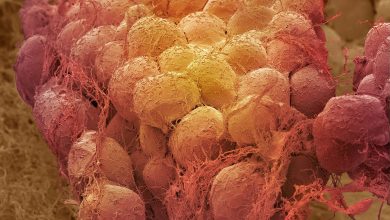دماغك المنتج

زيادة إنتاجيتك أمر سهل. يتعلق الأمر بإجراء بعض التغييرات البسيطة على روتينك أو سلوكك أو تفكيرك، وسوف ترتفع إنتاجيتك. على الأقل هذا ما تزعمه مقالات لا حصر لها عبر الإنترنت. أما العلم الحقيقي فيبين لنا أن الأمور لا تسير على هذا النحو. ومجرد الاطلاع على عدد ضئيل من الأبحاث سيكشف أن بعض الادعاءات الأكثر شيوعاً حول الكيفية التي يمكن وفقها زيادة الإنتاجية تنهار أمام الأدلة. فيما يلي بعض الخرافات الأكثر شيوعاً حول زيادة الإنتاجية، جنباً إلى جنب مع عدد من الأساليب التي لها أساس علمي أكثر صرامة.
“الاستيقاظ عند الرابعة صباحاً سيجعلك أكثر إنتاجية!” (خطأ)
يُزعَم على نحو متكرر أننا سنكون أكثر إنتاجية إذا استيقظنا مبكراً. مبكراً جداً. وفقاً لمقال نُشر في وول ستريت جورنال في العام 2016 ينهض الأشخاص الأكثر نجاحاً (ومن ثم الأكثر إنتاجية) عادة عند الرابعة صباحاً.
هذه الفكرة تحتوي على بعض المنطق. على سبيل المثال إذا كنت مستيقظاً فيما لا يزال الآخرون نياماً، فلن يشتتوا انتباهك، وستكون أكثر إنتاجية.
ومع ذلك يوجد عديد من الأسباب التي تجعل الاستيقاظ عند الرابعة صباحاً غير مثمر. أحد الأسباب المهمة يأتي من تركيبتنا البيولوجية: النوم أمر حاسم في قدرتنا على أداء وظائفنا، والحرمان من النوم يضر أكثر مما ينفع.
القدر المعتاد من النوم الصحي للبالغين يتراوح من سبع إلى تسع ساعات. النوم ساعاتٍ أقل من ذلك يترك بسرعة آثاراً سلبية في الصحة، مما يكون له أثر ضار في قدرتنا على التركيز، وفي مزاجنا وذاكرتنا، وتحملنا للإجهاد وغير ذلك. أن نجبر أنفسنا على الاستيقاظ عند الرابعة صباحاً يعني أن نحصل على قسط أقل من النوم، وأننا سنكون أقل إنتاجية نتيجة لذلك.
يبدو أن بعض الناس قادرون على فعل ذلك من دون نتائج عكسية، لكونهم بطبيعتهم ممن “يستيقظون مبكراً”. لكن الاقتداء بمثل هؤلاء قد يكون في غير محله. فقد ذكرت دراسة أجرتها مؤسسة النوم الوطنية National Sleep Foundation أن “الأفراد الذين اعتادوا النوم أقل من المعدل الطبيعي قد تظهر عليهم علامات أو أعراض مشكلات صحية خطيرة، وإذا فعلوا ذلك بنحو إرادي، فقد يعرضون صحتهم وعافيتهم للخطر”. وتقترح دراسة أخرى أن النوم ساعات أقل بكثير من المتوسط من المرجح أن يكون مفروضاً على الذات أكثر من كونه شيئاً طبيعياً، وسيؤدي إلى نقص تراكمي في النوم يضر بالصحة.
بوجه عام بينما قد تكون هناك بعض المزايا الإنتاجية للاستيقاظ في ساعات الصباح الأولى، فإنها سرعان ما تزول بسبب عواقب نقصان النوم.

“جِدْ منطقة تركيزك” (صح)
مع كل ما نوقش حتى الوقت الحالي، من المهم مراعاة ملاحظة مهمة وهي أن كل شخص يختلف عن الآخر، وما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لآخر. تؤدي الفروق الفردية دوراً مهماً في الطريقة التي ننتهي بها إلى أن نكون منتجين. ولكن إذا تمكنت في النهاية من معرفة العوامل التي تلائمك على أفضل وجه، فسيكون من الحكمة الاستفادة من وعيك بها، لأنه يزيد من فرصتك في الوصول إلى حالة “التدفق” المعرفي Cognitive ‘flow’، والتي يعبر عنها معظم الناس بعبارة “منطقة التركيز”.
يمكن القول إن التدفق المعرفي هو الحالة الذهنية الأكثر إنتاجية التي يمكن أن نكون فيها. يحدث ذلك عندما نكون أكثر تركيزاً على مهمة ما، أياً كانت، ومن ثم أن نظهر ونحن نؤديها أقصى مستوى ممكن من المهارة نتحلى به.
على الرغم من مقدار الوقت والجهد الذي يكرسه الأشخاص للوصول إلى حالة التدفق، فإنه يبقى أمراً صعباً. والسبب في ذلك على الأرجح هو أن أدمغتنا تضطلع بالعشرات من الأشياء في وقت واحد، وفي كثير من الأحيان، كما هي الحال مع أنظمة الانتباه لدينا، فإن عديداً من هذه الأشياء سيقف في طريق أشياء أخرى.
على الرغم من ذلك، في بعض الأحيان، تتحد كل الأجزاء المتناثرة من وعينا وتركز على مهمة واحدة محددة، ومن ثم ندخل في حالة التدفق. تكمن المشكلة في أن ما يشغل الأجزاء العديدة من دماغك سيختلف من شخص إلى آخر. لذا من المحتمل أن يكون الإعداد المحدد الذي يسمح لك بأن تكون أكثر إنتاجية فريداً بالنسبة إليك.
النقطة المهمة هي أن قراءة المقالات وأعمدة النصائح حول كيف تكون أكثر إنتاجية أمر جيد وحسن، ولكن لن يعرف أحد الطريقة الأنسب لزيادة إنتاجيتك خيراً منك.
“موسيقى الخلفية مفيدة” (صح)
هناك كثير من الجدل في الوقت الحالي بشأن ما هو أكثر إنتاجية: هل هو العمل من المنزل، أو العمل في المكتب؟ ويجادل أصحاب كلٍّ من الرأيين باستمرار بأن الطريقة الأخرى تزخر بمزيد من مسببات الإلهاء عن العمل.
ومع ذلك فإن الشيء الوحيد الذي نادراً ما يُذكر هو أن بعض عوامل التشتيت يمكن أن تكون مفيدة للإنتاجية. يفضل بعض الأشخاص العمل في صمت نسبي، ولكن يجد كثيرون أنهم أكثر إنتاجية مع نوع من الضوضاء في الخلفية. بوجه عام يأخذ هذا شكل موسيقى الخلفية. هذا يساعد، بدلاً من صرف الانتباه، بسبب الكيفية التي يعمل وفقَها انتباهُنا. في الأساس لدينا نظامان للانتباه: النظام الواعي الذي نوجهه ونتحكم فيه، والآخر اللاواعي الذي ينبهنا إلى أي شيء مهم تلتقطه حواسُّنا ويحوِّل تركيزنا نحوه.
عندما نحاول التركيز على مهمة ما، يكون انتباهنا الواعي مشغولاً، ولكن ما زال من الممكن أن يلهيه عن ذلك النظام اللاواعي. وإذا كنا في صمت تام فإن أي صرير أو تنهدات أو همهمة أو أصوات عشوائية أخرى تبرز أكثر، وهذا يعني مزيداً من التشتت لانتباهنا اللاواعي، مما يعيق إنتاجيتنا. ولكن إذا عمدنا إلى تشغيل موسيقى في الخلفية، فإنها ستغطي على الضوضاء وتستحوذ على انتباهنا اللاواعي، مثل إعطاء طفل يشعر بالملل لعبة ليلعب بها في أثناء محاولتنا أن نعمل. من الواضح أن نوع الموسيقى سيُحدث فرقاً. الأشياء التي تحتوي على كلمات ليست جيدة لأن المعلومات اللغوية أكثر تحفيزاً لأدمغتنا، والموسيقى التي لها تأثير سلبي في الحالة المزاجية يمكن أن تستنزف الدافع للإنتاج. من الغريب أن أحد أنواع الموسيقى التي يبدو أنها تعزز الإنتاجية والتركيز هي الموسيقى التصويرية لألعاب الفيديو. إنه أمر منطقي حقاً؛ إنها موسيقى مصمَّمة لتكون محفِّزة في حين أنك تركز على شيء آخر.
لكن هناك عديداً من الحالات التي يمكن فيها للضوضاء الخلفية والموسيقى أن تعزز الإنتاجية بالفعل ولا تعطلها.
“الاستيقاظ بعد نوم كافٍ أفضل من الاستيقاظ عند الرابعة صباحاً” (صح)
لقد رأينا سابقاً أن إجبار النفس على الاستيقاظ قبل الفجر لنكون أكثر إنتاجية يمكن أن يعطي نتيجة عكسية. ومع ذلك يجب ألا تكون الأمور على هذا النحو. في الحقيقة أيُّ وقت تستيقظ فيه يمكن أن يكون مثمراً، إذا حصلت على قسط كافٍ من النوم. لذا إذا استيقظتَ عند الساعة 4 صباحاً بعد أن تخلد للنوم عند الساعة 8 مساءً، فمن المؤكد أنك قد قضيت وقتاً كافياً في النوم. يوجد عديد من الفوائد الصحية للحصول على قسط كافٍ من النوم. فهو يعزز الذاكرة، ويساعد على التركيز، ويحسن الصحة العامة، ويحسِّن المزاج ويقلل من الانفعال، وكل ذلك يزيد من قدرتك على أن تكون منتجاً.
يمكن أن يساعد النوم على الإنتاجية بطرق أخرى. فخلال النوم تعالج أدمغتنا جميع الذكريات والأفكار التي تراكمت لدينا خلال اليوم، وتدمجها في شبكاتنا العصبية. هذا هو السبب في أن قول “الصباح رباح”، أو تأجيل البت في مسألة ما إلى صباح اليوم التالي، هو نهج مشروع لحل المشكلات. إذا لم نتمكن من التعامل مع مشكلة ما، فإن تأجيلها لليوم التالي يعني أن جزءاً أكبر من عقولنا سيرتبط بتجربتنا معها، مما يفتح طرقاً جديدة، في حين أن البقاء مستيقظين طَوال الليل في محاولة للتوصل إلى حل سيكون أقل فاعلية. لذا نعم، النوم مهم للإنتاجية، أكثر من الاستيقاظ في أوقات معينة.
“لدينا جميعاً الأربع والعشرون ساعة نفسها! ” (خطأ)
أكثر الناس نجاحاً تتألف أيامهم من 24 ساعة، تماماً مثل أي شخص آخر. تتضمن كثير من “النصائح” حول زيادة الإنتاجية هذه الملاحظة. المعنى الضمني هو أنك، كشخص أقل نجاحاً، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه إذا استخدمتَ وقتك على نحو أفضل. يفترض أن الهدف من هذا هو تحفيزك على أن تكون أكثر إنتاجية.
لقد عارض كثيرون هذا الادعاء. نعم، كلنا لدينا 24 ساعة في اليوم. لكن القدرة على استخدام تلك الساعات بنحو منتج تختلف بقدر كبير من شخص إلى آخر.
السياق هو كل شيء. الشخص الذي يعمل ليلاً لدفع تكاليف دراسته خلال النهار لن تكون لديه القدرة نفسها على استخدام وقته “بنحو منتج” مثل شخص وُلد مليونيراً بفضل منجم ألماس يملكه والده. من باب الافتراض.
وبالمثل هناك تأثير الأدوار المجتمعية للجنسين وعوامل أخرى لا تساعد. في النهاية من الأسهل بكثير استخدام الوقت بنحو منتج عندما يكون لديك المال والموارد، أو أفراد مخلصون يعتنون بالمطالب “غير المنتجة” للحياة اليومية. والغالبية العظمى من الناس يفتقدون هذه الأشياء.
أيضاً فإن فكرة أنه يجب عليك استخدام الأربع والعشرين ساعة كلها بنحو منتج هي فكرة غير منطقية من الناحية الموضوعية. لقد أكد علم النفس مراراً وتكراراً أهمية التوازن الصحي بين العمل والحياة بالنسبة إلى رفاهية الفرد (ومن ثم الحفاظ على مستوى الإنتاجية). إن تكريس كل ساعة ممكنة “لتكون منتجاً” يتعارض مع ذلك.
إن الادعاء أن “لدينا جميعاً الأربعَ والعشرين ساعة نفسها” يقلل بقدر كبير من حقيقة أن قلة من الناس لديهم خيار استخدام ذلك الوقت بنسبة %100 بنحو منتج.
“الانشغال الدائم يعني أنك أكثر إنتاجية” (خطأ)
عندما يظهر مسؤول في مكان العمل، فأنت في حاجة إلى “أن تبدو مشغولاً”، لأنك إذا لم تكن في الظاهر منشغلاً بعديد من المهام، فأنت لستَ منتجاً.
الفكرة القائلة بأن الانشغال المستمر هو الطريقة الوحيدة لتكون منتجاً حقاً هو افتراض بديهي لدى كثير من الناس. إنه يردد صدى الادعاء بأن “لدينا جميعاً الأربع والعشرين ساعة نفسها” الوارد سابقاً، مع الإشارة ضمنياً إلى أن أي وقت لا يُنفق بنحو منتج فهو إهدار للوقت. غالباً ما يُشاد بأولئك الذين يؤدون عديداً من المهام والأدوار في وقت واحد على أنهم المثل الأعلى المنتج. لكن العلم يرى الأمر على نحو مختلف تماماً.
في الحقيقة من المعروف منذ فترة طويلة أن تعدد المهام أو “تبديل المهام” Task switching يؤدي في الواقع إلى تآكل إنتاجيتك. على الرغم من أن الأمر مثير للإعجاب، فإن العقل البشري لديه موارد محدودة عندما يتعلق الأمر بالانتباه والذاكرة العاملة، أي قدرتنا على التركيز على الأشياء والتفكير فيها. كلاهما من الصفات الأساسية لأداء المهام بنجاح وبنحو مثمر، وإذا أغرقت انتباهك وذاكرتك العاملة بكثير من المتطلبات في وقت واحد، فإنك بذلك ستحد من قدرتك على أداء المهام الأكثر مباشرة بنحو فعال.
يمكن أن يكون لهذا بعد ذلك تأثيرات غير مباشرة على إنتاجية الآخرين أيضاً. سيعاني الجميع زيادةَ عبء العمل لأن أحد الزملاء لم يؤدِّ عمله على وجه صحيح، مما يعني أنه يتعين على الآخرين إصلاح الأخطاء التي ارتكبها (وإذا لم تكن قد اختبرت ذلك، فهذا يعني أن الأمور ليست على ما يرام…).
ولكن حتى إذا كنتَ قادراً بطريقة ما على التعامل مع عبء العمل الزائد بنجاح وفعالية، فإن هذا يعود عليك بالضرر، مثلما تُبين لنا بوضوح حالات الإرهاق المتزايدة في مكان العمل.
بفضل الطريقة التي نعمل بها نحن وأدمغتنا، غالباً ما تتعلق الإنتاجية بالجودة أكثر من الكمية. أي شخص يصر على محاولة الاضطلاع بأكبر قدر ممكن في وقت واحد إنما يُلحق الأذى بنفسه، أو كما يُقال: كمن يطلق النار على قدمه.
“اذهب للمشي وزيِّنْ مكان عملك بالنباتات” (صح)
من الشائع إلى حدٍّ ما أن ينعش الناس مكان عملهم من خلال الاعتناء بنباتات داخلية، وأن يتطلعوا إلى مكتب يُطلون من نافذته على المتنزه القريب أو منطقة مشجرة. تستهجن بعض المؤسسات مثل هذه الأشياء، وتختار بدلاً من ذلك قدراً أكبر من الاتساق، ولكن بوجهٍ عام يتوق الموظفون إلى رؤية نباتات (ومناظر خضراء) في مكان العمل ويقدرونها.
لمَ ذلك؟ لماذا نخصص كمجتمع كثيراً من الوقت والجهد في تشييد مبانٍ تحل محل الطبيعة لنعمد بعدها إلى جلب أجزاء منها باستمرار إلى الداخل؟
ليس فقط لأسباب جمالية. اتضح أن النباتات وأوراق الشجر وأنواعاً أخرى من المساحات الخضراء مفيدة بالفعل للإنتاجية. وقد بين ذلك عديدٌ من الدراسات التي تشير إلى زيادة الإنتاجية عند إدخال نباتات إلى مكان العمل. يحدث هذا، جزئياً على الأقل، بفضل عملية استعادة الانتباه Attention restoration والتي تسمى أحياناً “الانبهار” Fascination. تكمن المشكلة في أن معظم البيئات البشرية الحديثة، توجد فيها أشياء تجذب انتباهنا “على نحو نشط”، مثل الشاشات واللوحات الإعلانية والكتابة، وعديد من الألوان والأشكال، ومجموعة متنوعة من الناس تتغير باستمرار، وغير ذلك. تحبذ أدمغتنا كل هذه الأشياء، بالتأكيد، لكن عليها دائماً أن تعمل بجد لتنتبه لها جميعها، وفك رموز المعلومات الحسية التي تقدمها، وهلم جراً. ولكن، كما رأينا سابقاً، تمتلك أدمغتنا موارد محدودة فقط للاضطلاع بكل هذا، لذا فإنها ستُستنفد في النهاية. ومع ذلك لا يبدو أن هذا يحدث عندما ننظر إلى النباتات والمحفزات المماثلة. عندما ننظر إلى المساحات الخضراء الطبيعية، يبدو أن أدمغتنا تنشغل بها من دون أن ترهقها. إنه المكافئ المعرفي لقراءة كتاب جيد وأنت في وضعية الاسترخاء؛ إنها تفعل شيئاً ما، لكنه شيء منعش بدلاً من أن يكون متطلباً.
هذا هو السبب في أن المساحات الخضراء مفيدة للإنتاجية. إنها تغذي موارد دماغك. لذا إذا شعرت بأنك في حاجة إلى الذهاب في نزهة “لتصفية ذهنك”، فمن المحتمل أنك تفعل ذلك الأمر حرفياً أكثر مما يبدو لك.
“يجب أن تكون سعيداً في عملك” (خطأ)
وفقاً لكثير من الناس، ترتبط الإنتاجية بالسعادة. كما هي الحال بقولنا كلما كنتَ أكثر سعادة، زادت إنتاجيتك.
مرةً أخرى، في الأمر بعض المنطق. إذ يكون لدينا في كثير من الأحيان دافع غريزي لفعل أشياء نجدها مجزية وتجعلنا سعداء، وتجنب الأشياء التي نجدها غير سارة. تكشف الدراسات العلمية أيضاً أن العمال السعداء هم أكثر إنتاجية بنسبة %12. لذا إذا كانت لديك قوة عاملة من 100 موظف، وكلهم سعداء، فستحصل على إنتاجية 112 موظفاً، من دون أي تكلفة إضافية! لذلك ليس من المستغرب أن تركز عديد من المؤسسات على رضا موظفيها.
ومع ذلك فإن التشديد ببساطة على فكرة أن “السعادة = إنتاجية” يتغاضى عن أدلة كبيرة على أن العكس صحيح. على سبيل المثال كشفت دراسات أخرى أن الموظفين السعداء باستمرار يمكن أن يكون لهم تأثير سلبي في الإنتاجية في مكان العمل. فهم معرَّضون للانهيار بنحو أسرع خلال الفترات الصعبة، ويسهل استنفادهم (السعادة المستمرة تستنزف الطاقة)، ويمكن أن يكونوا أكثر أنانية.
أيضاً هناك فوائد مثمرة لاختبار مزيد من المشاعر السلبية. لقد ثبت أن الخوف والغضب والتوتر والحسد تجعل الناس أكثر إنتاجية في المواقف المختلفة.
إضافةً إلى ذلك فإن إجبار الناس على أن يكونوا سعداء، سواء من خلال تقديم النصح لهم حول كيف يمكن أن يكونوا منتجين، أو إصرار أصحاب العمل على تأدية “الخدمة بابتسامة”، غالباً ما يؤدي إلى نتائج عكسية. تكشف الدراسات أنه إذا اعتقد الناس أنهم يجب أن يكونوا سعداء، فمن الصعب عليهم تحقيق ذلك. إنها مثل أن تصير هوايتك هي وظيفتك؛ عندها تتوقف عن الاستمتاع بها.
هذا يغذي مسألة “الإيجابية السامة” Toxic Positivity بكاملها من خلال الإصرار على أن الناس يجب أن يكونوا سعداء في معظم الأوقات، وأن الأمر مُلقى تماماً على عاتقهم (لأنه يمكننا جميعاً اختيار حالتنا العاطفية، على ما يبدو). هذا يمكن أن يؤدي بسرعة إلى النتيجة المعاكسة تماماً.
حتى لو جعلك الشعور بالسعادة أكثر إنتاجية، فإن الجهود المبذولة لفرض هذه النتيجة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بسهولة.
“النظام الغذائي وممارسة الرياضة يحسِّنان الإنتاجية، ما دُمتَ تجاهلتَ صرعات الموضة” (صح)
من بين المقالات التي لا تعد ولا تحصى حول كيف يمكن أن نكون منتجين باتباع نصيحة “الأكثر نجاحاً”، يركز كثير منها على نظام الفرد الغذائي وتمارينه الرياضية.
في حين أن اتباع روتين نشاطهم البدني غير ممكن في العادة لأسباب عملية تماماً (معظم الناس ليست لديهم صالة ألعاب رياضية منزلية، ومدرب شخصي، وأربع ساعات فراغ في اليوم يكرسونها لذلك)، غالباً ما يمكن تصنيف وجباتهم الغذائية على أنها سخيفة. ربما قرأتَ مقالاً عن بعض الأثرياء الذين يتناولون على الإفطار يومياً وعاءً من أنواع من ثمار التوت التي لم نسمع بها من قبل، والأوراق الخضراء التي تعد “أطعمة فائقة” Superfoods، ويشربون معها عدة أكواب من الماء المؤين، أو إفرازات حوت بيلوغا، أو شيءٍ آخر بمثل غرابتها.
إذا بدت ادعاءاتهم على أنها متبجحة ومنافقة، فذلك لأنها كذلك. إنها طريقة للتباهي بمكانتهم وإنجازاتهم أمام الجماهير الجاهلة. ولكن إذا تجاهلنا الجوانب السخيفة، فمن المقبول القول إن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن يساعدا إلى حد كبير على زيادة الإنتاجية.
مراراً وتكراراً تبين أن التمارين المنتظمة لها عديد من الفوائد للجسم والعقل. فعقلك هو في النهاية عضو آخر، وكلما كان شكل جسمك أفضل، زادت الموارد التي يمكنه تخصيصها للدماغ مما يؤدي إلى تحسين أداء الوظائف والإنتاجية.
يمكن أن يكون للنظام الغذائي تأثير مباشر في أدمغتنا أيضاً. وفي حين أن العواقب الصحية غير المباشرة للأطعمة “غير المفيدة” Junk foods تستحق أن نأخذها في الاعتبار، تظهر الدراسات الحديثة أن مثل هذه الأطعمة يمكن أن يكون لها آثار سلبية سريعة في عمل الدماغ، مما يؤثر في قدرتنا على التركيز، والبقاء متحمسين للمهام التي نعمل عليها.
لذا في حين أنك لا تحتاج إلى ملء ثلاجتك بأحدث الأطعمة الخارقة، فإن تحسين نظامك الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن يعززا إنتاجيتك.
“العمل الجاد يؤتي ثماره دائماً” (خطأ)
إذا كنتَ تريد أن تكون منتجاً، لتحقيق شيء ما، فليس عليك سوى أن تعمل بجد، وستحصل على ذلك. لأن العمل الجاد دائماً يؤتي ثماره.
هذا هو الشعار الذي يتبناه كثيرون. للأسف نادراً ما تنطبق مثل هذه المعادلة على أرض الواقع. بقدر ما قد نرغب في الاعتقاد بخلاف ذلك، وفيما يعمل عدد لا يحصى من الأشخاص بجِدٍّ بالقدر نفسه من أجل الأهداف نفسها، فإن العامل الأكثر أهمية سيكون في الواقع… هو الحظ. للأسف لا يمكنك أن تقول للناس: “كونوا محظوظين” بالطريقة نفسها التي يمكنك بها إقناعهم بأن يكدوا في العمل.
في الواقع إخبار الناس بأن العمل الجاد يؤدي حتماً إلى الإنتاجية والنتائج التي يرغبون فيها هو أمر غير مفيد. أدمغتنا حساسة للتوازن بين الجهد والمكافأة. تقيِّم أنظمتنا اللاواعية باستمرارٍ مقدارَ العمل الذي ستتطلبه المهمة والنتيجة المحتملة لبذل هذا الجهد، وتسأل: “هل يستحق كل هذا العناء؟” وعندما لا يُكافأ الجهد الذي نبذله كما هو متوقع، فإنه يسبب إجهاداً ويترك لدينا مشاعر سلبية. يُعتقد أن كل هذا عامل رئيس وراء الضغوط الناجمة عن مكان العمل، لأن الوظائف الحديثة تعني في كثير من الأحيان أن الشخص الذي يبذل الجهد في شيء ما بعيد كل البعد عن النتيجة النهائية.
بالنظر إلى كل هذا، لماذا لا يزال الناس يعتقدون أن العمل الجاد يؤتي ثماره دائماً؟ ربما بسبب “فرضية العالَم العادل”، والتحيز المعرفي Cognitive bias الذي يجعلنا نفترض أن العالم مكان عادل، وأن العمل الجيد يُجازى بالمكافأة، والأفعال السيئة تُقابَل بالعقاب. كما أنه يفسر سبب إصرار الأشخاص الناجحين على أنهم مسؤولون وحدهم عن نجاحهم، وهو نوع شائع من النصائح حول الإنتاجية.
د. دين بيرنيت Dean Burnett
(@gar wboy) دين كاتب في علم الأعصاب. أحدث كتبه هو سايكولوجيكال Psycho-Logical (منشورات: Guardian Faber)